اشتُهر القرن الرابع الهجري بقرن سيادة الشيعة في العالم الإسلامي، فإذا نظرنا في قلب الخلافة الإسلامية العباسية في العراق رأينا سيطرة البويهيين، وإذا نظرنا إلى الشام وجدنا الحمدانيين، وإذا نظرنا إلى مصر وفلسطين وجنوب الشام وسواحله وحتى بلاد المغرب الأقصى وجدنا الفاطميين، وإذا يممنا وجهنا شطر الجزيرة العربية وجدنا القرامطة، وإذا أوغلنا إلى اليمن وجدنا الصُّليحيين، كل هذه الدول والقوى السياسية كانت شيعية بمختلفة طوائفها بين الإسماعيلية والاثنى عشرية والباطنية.
وفي منتصف القرن التالي، أهدى القدر إلى العالم الإسلامي السلاجقة، الذين تمكنوا في أقل من نصف قرن على ظهورهم السياسي من السيطرة على وسط آسيا وأفغانستان وإيران وحتى العراق والشام، بل ووصلت سنابك خيولهم إلى بحر مرمرة على الجهة المقابلة من القسطنطينية، وإذا كان القدرُ قد أخرج السلاجقة لكي يعيدوا إلى العالم الإسلامي، وأهل السنة قوتهم السياسية التي تضعضعت مع الدول الشيعية في المشرق والمغرب، فقد هندس هذا التوسع السياسي والثقافي رجل حكيم عاقل هو العلامة الوزير نظام المُلك الحسن بن علي بن إسحاق الطوسي الشافعي (ت 485هـ/1092م)، الذي أدرك الأهمية الدينية والثقافية والفكرية والسياسية لإقامة مشروع ثقافي يكون على توازٍ مع المشروع السياسي الذي شرع السلاجقة في إحلاله.
لقد آمن الطوسي بدور المؤسسات الدينية والتعليمية التقليدية التي تمثّلت في الجوامع والمساجد وبيوت العلماء، ولكنه أيقن بأن الحاجة باتت مُلحة في ظل المستجدات الدينية وتحدياتها في ظل هيمنة الشيعة على المشرق والمغرب لقرن ونيف إلى مؤسسات جديدة ترعاها الدولة، وتقف خلفها، وتعمل من خلالها على نشر الإسلام ومحاربة الأفكار المتطرفة والإلحادية.
وقد ظلت الجوامع والمساجد حتى القرن الرابع الهجري مقصداً أساسياً من مقاصد العلم ونشره، فضلاً عن دورها الديني والتعبّدي، وقد كان الفقهاء من بين أكثر العلماء حضوراً، وكان ذلك -كما يوضح آدم متز في كتابه "الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري"- طبيعياً؛ لأن الفقهاء كانوا يُعلّمون العلم الذي يُؤهل أصحابه لتولي مناصب يعيشون منها، وضرب على ذلك العديد من الأمثلة فقد كان أبو حامد بن محمد الأسفراييني (ت 406هـ/1015م) إمام المذهب الشافعي في عصره، حتى قيل إنه أفقه وأنظر منه، وكان في الوقت عينه يُدرّس بمسجد عبد الله بن المبارك في بغداد، وكان يحضر مجلسه ما بين ثلاثمائة وسبعمائة فقيه.
ولكن منذ القرن الرابع الهجري بدأت فكرة المدارس تظهر بصورة فردية غير مؤسسية في مناطق متفرقة من العالم الإسلامي لا سيما في العراق وخراسان، فالعلامة التاج السبكي يقرر أن شيخه العلامة شمس الدين الذهبي (ت 748هـ/1349م) يقول إن المدرسة البيهقية أُنشئت قبل أن يُولد نظام الملك الطوسي بقرن على الأقل، وهو الأمر الذي يؤكده شيخ المؤرخين المقريزي (ت 845هـ/1441م) قائلاً: "والمدارس مما حدث في الإسلام، ولم تكن تعرف في زمن الصحابة ولا التابعين، وإنما حدث عملها بعد الأربعمئة من سني الهجرة، وأوّل من حفظ عنه أنه بنى مدرسة في الإسلام أهل نيسابور، فبُنيت بها بالمدرسة البيهقية، وبنى بها أيضاً الأمير نصر بن سبكتكين مدرسة، وبنى بها أخو السلطان محمود بن سبكتكين مدرسة، وبنى بها أيضاً المدرسة السعيدية، وبنى بها أيضاً مدرسة رابعة".
وكان الوقف/الحبس هو الداعم الأول والأكثر قوة وتأثيراً في نجاح هذه الفكرة الجديدة، وقد كان الواقفون أو المنشئون والممولون لهذه المدارس/الكليات أصحاب الحق الحصريّ في وضع البرنامج المناسب لها طالما لا تخالف اعتقاد أهل السنة والجماعة، وأغراض الدراسة في هذه المعاهد العلمية في علوم الأصول والفروع أو حتى العلوم الأخرى كالطب وغيرها؛ إلا إذا رأى بعض الفقهاء تغيير بعض شروط الواقفين مراعاة للمستجدات والمصلحة العامة فيما بعد.
وسنجدُ قاضي قزوين في إيران عبد الحميد بن عبد العزيز بنى مدرسة للفقهاء الشافعية في مدينته، ودفن حين وفاته سنة 557هـ في هذه المدرسة، وهذه الأميرة الأيوبية أخت السلطان صلاح الدين الأيوبي ست الشام زمرد خاتون تتبرع بدارها الواسعة في دمشق، وتجعلها وقفاً لإنشاء مدرسة كانت فيما بعد من كبريات مدارس الفقه والحديث في بلاد الشام، كما بنت مدرسة/كلية أخرى؛ لذا عُرفت في التاريخ بـ"وافقة الشاميتين بدمشق"، إحدى هاتين المدرستين كانت تطل على منظر بهيج عند نهر برَدى، وآلاف من الأمثلة الأخرى على انتشار همة المسلمين بكافة طبقاتهم في إنشاء المدارس، والعمل على ضمان استمرارها ونجاحها.
نظام الملك الطوسي.. وزير السلاجقة السياسي
ونأتي إلى وزير السلاجقة ومنظّرهم ومدبر مشروعهم السياسي والثقافي نظام الملك الطوسي وهو من أوائل وأشهر من بنى المدارس/الجامعات في تاريخ الإسلام الوسيط ووزير السلاجقة الأشهر، كان الطوسي أول من خصّص الرواتب والأجور للمدرّسين والمعيدين وكل العاملين في مدارسه، كما تكفّل بإعاشة الطلبة وتحمّل جميع مصروفاتهم اليومية والدراسية وما يحتاجون إليه من مستلزمات في المأكل والمشرب وأدوات الكتابة والمكتبات والنساخة وغيرها. قال المؤرخ ابن خلّكان في طبقاته عن جهود الوزير السلجوقي نظام الملك الطوسي: "بنى المدارس والرُّبط والمساجد، وهو أول من أنشأ المدارس فاقتدى به الناس، وشرع في عمارة مدرسته ببغداد سنة سبع وخمسين وأربعمئة".
ونسبةً إليه شرع نظام الملك الطوسي في إنشاء المدرسة النظامية الكبرى في بغداد التي لا تزال شاخصة حتى يومنا هذا، والتي صارت منذ ذلك الحين النموذج والمقياس الذي نسج الناس على منواله شكل المدارس وطرائق التربية والتعليم فيها، وقد أدرك نظام الملك الطوسي أن مواجهة الخطر الشيعي الباطني والإسماعيلي يكون تعليمياً وثقافياً بالتوازي مع المواجهة العسكرية التي كانت على أشدها حينذاك.
وكان نظام الملك الطوسي عالماً فقيهاً موسوعياً، وسياسياً خبيراً، على قدر كبير من الثقافة وله مؤلف مشهور للغاية هو "سياست نامه" (سير الملوك) في شؤون الحكم وتدبير السياسة ألّفه ليكون بمثابة النموذج والدستور لسلاطين السلاجقة الأتراك، وكان الطوسي محترماً مقدراً مسموع الكلمة عند أعظم سلاطين السلاجقة ألب أرسلان وابنه ملكشاه؛ لذا كان الرجل مثقفاً واعياً بأهمية هذا الميدان الخطر قبل أن يكون نظاماً للملك ووزيراً.
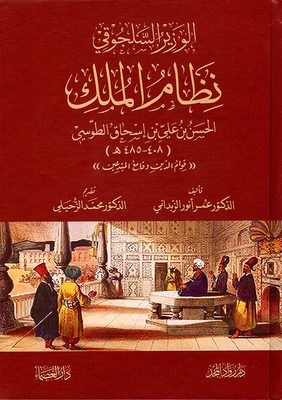
وقد أصبح التوسع في إنشاء المدارس مشروعاً مدروساً ومنفذاً في كافة أطراف ومراكز الدولة الإسلامية، وهو ما نفهمه من خلال هذا النص شديد الأهمية للمؤرخ الدمشقي شهاب الدين أبي شامة (ت 665هـ/1267م) الذي يقول: "ومدارسه في العلم مشهورة لم يخلُ بلد منها، حتى جزيرة ابن عمر التي هي في زاوية من الأرض لا يؤبه لها بنى فيها مدرسة كبيرة حسنة، وهي التي تُعرف الآن بمدرسة رضى الدين"، وجزيرة ابن عمر التي أشار لها أبو شامة هنا تقع بالقرب من الموصل شمال العراق، وكانت موضعاً هادئاً، ومنشأ لأسرة اشتُهرت بالعلم والأدب هي الأسرة الأثيرية التي أنجبت العلماء عز الدين بن الأثير وضياء الدين بن الأثير ومجد الدين بن الأثير، وكلهم لمع في ميدان الفقه والحديث والتاريخ، ولا شك أن بزوغ هذا الجيل في النصف الثاني من القرن السادس الهجري كان أثراً مباشراً من آثار التعليم المدرسي الجديد والثوري الذي أسّسه الوزير نظام الملك الطوسي، وثمرة من ثمرات تعبه ورؤيته البعيدة.
لقد كانت المدارس النظامية في مُدن بغداد ونيسابور للحق أكبر من أن تكون مدرسة بمفهومنا الحالي الضيق، لقد كانت من أكبر الجامعات العالمية وقتها، لا تتخصص في دراسة علم واحد، ولا تتقيد بمدرسة فقهية بعينها، بل تفتح الباب أمام العلوم والمعارف النقلية والعقلية والتجريبية، وقد حرص الوزير نظام الملك الطوسي على جذب أكابر الشيوخ والعلماء من ذوي التخصصات المختلفة ممن شُهد لهم بالعلم الراسخ في عصره، ولهذا السبب لم يكن علماء المدرسة النظامية في بغداد من أهل بغداد أو العراق فقط، فنظرة إلى قائمة العلماء الذين درّسوا في هذه المدرسة تكشف لنا أنها كانت بالفعل جامعة عالمية كبرى، فهذا العلامة الشافعي أبو إسحاق الشيرازي عالم الشافعية في زمانه من أهل فيروز أباد في فارس، يقال إن نظام الملك الطوسي بنى له المدرسة النظامية خصيصاً، وكان علامة زمانه، شيخ هذه المدرسة، وهذا أبو القاسم علي بن أبي يعلى السغدي القادم من منطقة السغد بين بخارى وسمرقند يرتقي معلماً في المدرسة النظامية و"كانت له يد قوية باسطة في الجدل" والمنطق كما يقول المؤرخون.
كما درّس في هذه المدرسة مشاهير آخرون قادمين من بلدان مختلفة مثل يوسف بن عبد الله الدمشقي الشامي إمام الفقه والتفسير القادم من دمشق إلى بغداد كان أيضاً أحد علماء هذه الجامعة أو المدرسة، والعلامة الصوفي الشهير أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري، القادم من نيسابور أو نيشابور في أقصى شرق إيران اليوم، وهو إمام الأصول والتصوف والتفسير وكان له دروس في المدرسة النظامية في حدود سنة 469هـ، ويبدو أنه لكونه أشعري الاعتقاد واجهَ اعتراضاً عنيفاً من حنابلة بغداد وعلمائها الكبار، وكانت حينذاك إحدى أكبر وأعظم قلاع المذهب الحنبلي في العالم الإسلامي، بل جاء من غرب العالم الإسلامي عدد من كبار العلماء للتدريس في هذه الجامعة العالمية، كأبي القاسم البكري المغربي الأشعري الذي لُقّب في بغداد بـ"علَم السّنة".
وفي مصادر التاريخ والتراجم سنجد قوائم طويلة للعلماء الذين درّسوا في هذه المدرسة أو الجامعة الكبرى وقد قدموا من كافة أقطار العالم الإسلامي من مشرقه إلى مغربه، على سبيل المثال سنجد العشرات منهم في كتاب "ذيل تاريخ بغداد" لابن الدبيثي، و"المنتظم" لابن الجوزي.
لقد كان من أهم ثمرات المدارس النظامية التي انتشرت في كافة بقاع العالم الإسلامي السلجوقي والعباسي، لا سيما العراق وإيران وخراسان ووسط آسيا وغيرها، أنها أعادت المكانة للإسلام بعدما اختطفته الحركات الباطنية والإلحادية في ذلك الوقت، وأخرجت جيلاً من العلماء الكبار الذين أسهموا في النهضة الإصلاحية العلمية والثقافية والسياسية التي ظهرت في القرن السادس الهجري مع جيل نور الدين محمود وصلاح الدين الأيوبي، وبل امتد أثرها إلى المستقبل في أزمنة المماليك والعثمانيين، كل ذلك بسبب رجل آمن بأهمية الإصلاح التعليمي والسياسي معاً.
أنتم أيضاً يمكنكم المشاركة معنا في قسم الآراء والتجارب الشخصية عن طريق إرسال مقالاتكم عبر هذا البريد الإلكتروني: [email protected]
مقالات الرأي المنشورة في “عربي بوست” لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.